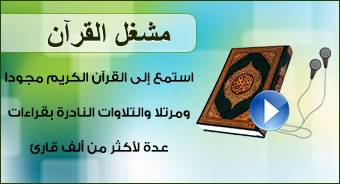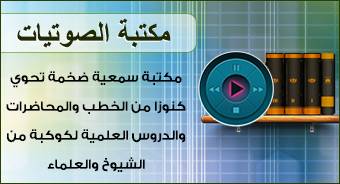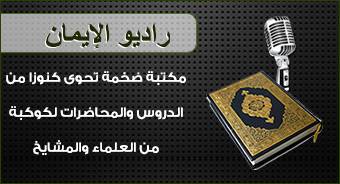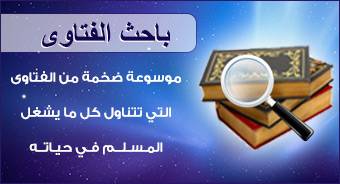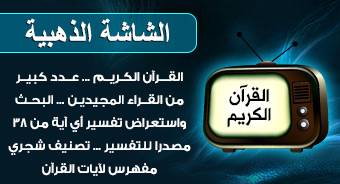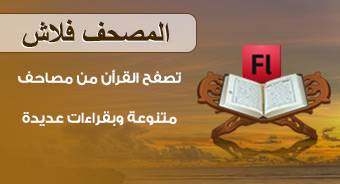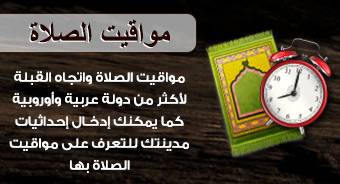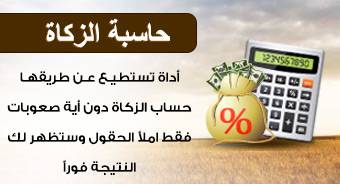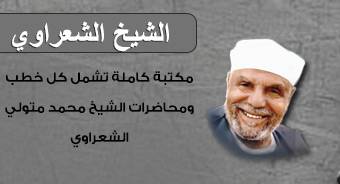|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (نسخة منقحة)
ولا حجة في هذا البيت وهذا قول قلق، وقال الجمهور: إنما هي استعارة لشنعة الأمر أي هذا حقه لو فهمت الجمادات قدره وهذا المعنى مهيع للعرب فمنه قول جرير: [الكامل] ومنه قول الآخر: [الطويل] وقال الآخر: [الوافر] والانفطار الانشقاق على غير رتبة مقصودة والهد الانهدام والتفرق في سرعة، وقال محمد بن كعب: كاد أعداد الله أن يقيموا علينا الساعة، وقوله: {وما ينبغي} نفي على جهة التنزيه له عن ذلك، وقد تقدم ذكر هذا المعنى، وأقسام هذا اللفظ في هذه السورة، وقوله: {إن كل من في السموات} الآية {إن} نافية بمعنى ما، وقرأ الجمهور {آتي الرحمن} بالإضافة، وقرأ طلحة بن مصرف {آتٍ الرحمن} بتنوين {آت} والنصب في النون، وقرأ ابن مسعود {لما آتى الرحمن}، واستدل بعض الناس بهذه الآية على أن الولد لا يكون عبداً وهذا انتزاع بعيد، و{عبداً} حال، ثم أخبر تعالى عن إحاطته ومعرفته بعبيده فذكر الإحصاء، ثم كرر المعنى بغير اللفظ، وقرأ ابن مسعود {لقد كتبهم وعدهم}، وفي مصحف أبيّ {لقد أحصاهم فأجملهم عدداً}.وقوله: {عداً} تأكيد للفعل وتحقيق له، وقوله: {فرداً} يتضمن معنى قلة النصر والحول والقوة لا مجير له مما يريد الله به وقوله: {سيجعل لهم الرحمن وداً} ذهب أكثر المفسرين الى أن هذا هو القبول الذي يضعه الله لمن يحب من عباده حسبما في الحديث المأثور، وقال عثمان بن عفان إنها بمنزلة قول النبي عليه السلام «من أسر سريرة ألبسه الله رداءها» وفي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد إلا وله في السماء صيت فان كان حسناً وضع في الأرض حسناً وإن سيئاً وضع كذلك» وقال عبدالرحمن بن عوف: إن الآية نزلت فيه وذلك أنه لما هاجر بمكة استوحش بالمدينة فشكا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية في ذلك، أي ستستقر نفوس المؤمنين ويودون حالهم ومنزلتهم، وذكر النقاش أنها نزلت في علي بن أبي طالب، قال ابن الحنفية: لا تجد مؤمناً إلا وهو يحب علياً وأهل بيته، وقرأ الجمهور {وُداً} بضم الواو، وقرأ أبو الحارث الحنفي بفتح الواو، ويحتمل أن تكون الآية متصلة بما قبلها في المعنى، أي إن الله تعالى لما أخبر عن إيتان {كل من في السماوات والأرض} في حالة العبودية والانفراد أنس المؤمنين بأنه سيجعل لهم في ذلك اليوم {وداً} وهو ما يظهر عليهم من كرامته لأن محبة الله لعبد إنما هي ما يظهر عليه من نعمه وأمارات غفرانه له.
فمثل لهم بإهلاك من قبلهم ليحتقروا أنفسهم، ويبين صغر شأنهم وعبر المفسرون عن اللد بالفجرة وبالظلمة وتلخيص معناها ما ذكرناه، والقرن: الأمة، والركز: الصوت الخفي دون نطق بحروف ولا فم وإنما هو صوت الحركات وخشفتها ومنه قول لبيد: فكأنه يقول أو تسمع من أخبارهم قليلاً أو كثيراً أو طرفاً خفياً ضعيفاً وهذا يراد به من تقدم أمره من الأمم ودرس خبره، وقد يحتمل أن يريد هل بقي لأحد منهم كلام أو تصويت بوجه من الوجوه فيدخل في هذا من عرف هلاكه من الأمم.
ويروى مزايلاً وقال الآخر: [البسيط] وقالت فرقة: سبب نزول الآية إنما هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمله من مشقة الصلاة حتى كانت قدماه تتورم ويحتاج الى الترويح بين قدميه فقيل له طاً الأرض أي لا تتعب حتى تحتاج الى الترويح، فالضمير في {طه} للأرض وخففت الهمزة فصارت ألفاً ساكنة، وقرأت {طه} وأصله طأ فحذفت الهمزة وأدخلت هاء السكت، وقرأ ابن كثير وابن عامر {طَهَ} بفتح الطاء والهاء وروي ذلك عن قالون عن نافع، ووروي عن يعقوب عن كسرهما، وروي عنه بين الكسر والفتح، وأمالت فرقة، والتفخيم لغة الحجاز والنبي عليه السلام، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بكسر الطاء والهاء، وقرأ أبو عمر و{طَهِ} بفتح الطاء وكسر الهاء، وقرأت فرقة {طَهْ} بفتح الطاء وسكون الهاء، وقد تقدمت، وروي عن الضحاك وعمرو بن فائد انهما قرأ {طاوي}. وقوله: {لتشقى} قالت فرقة: معناه لتبلغ عن نفسك في العبادة والقيام في الصلاة، وقالت فرقة: إنما سبب الآية أن قريش لما نظرت إلى عيش رسول صلى الله عليه وسلم وشظفه وكثرة عبادته قالت: إن محمداً مع ربه في شقاء فنزلت الآية رادة عليهم، أي إن الله لم ينزل القرآن ليجعل محمداً شقياً بل ليجعله أسعد بني آدم بالنعيم المقيم في أعلى المراتب، فالشقاء الذي رأيتم هو نعيم النفس ولا شقاء مع ذلك ع: فهذا التأويل أعم من الأول في لفظة الشقاء، وقوله: {إلا تذكرة} يصح أن ينصب على البدل من موضع {لتشقى} ويصح أن ينصب بفعل مضمر تقديره لكن أنزلناه تذكرة، و{يخشى} يتضمن الإيمان والعمل الصالح إذ الخشية باعثة على ذلك، وقوله: {تنزيلاً} نصب على المصدر، وقوله: {ممن خلق الأرض والسماوات العلى} صفة أقامها مقام الموصوف، وأفاد ذلك العبرة والتذكرة وتحقير الأوثان وبعث النفوس على النظر، و{العلى} جمع عليا فعلى.وقوله: {الرحمنُ} رفع بالابتداء ويصح أن يكون بدلاً من الضمير المستقر في {خلق}. وقوله: {استوى} قالت فرقة: هو بمعنى استولى، وقال أبو المعالي وغيره من المتكليمن: هو بمعنى استواء القهر والغلبة، وقال سفيان الثوري: فعل فعلاً في العرش سماه استواء وقال الشعبي وجماعة غيره: هذا من متشابه القرآن يؤمن به ولا يعرض لمعناه، وقال مالك بن أنس لرجال سأله عن هذا الاستواء فقال له مالك: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عن هذا بدعة وأظنك رجل سوء أخرجوه عني، فأدبر السائل وهو يقول يا أبا عبدالله لقد سألت عنها أهل العراق وأهل الشام فما وفق احد توفيقك.قال القاضي أبو محمد: وضعف أبو المعالي قول من قال لا يتكلم في تفسيرها بأن قال إن كل مؤمن يجمع على أن لفظة الاستواء ليست على عرفها في معهود الكلام العربي، فإذا فعل هذا فقد فسر ضرورة ولا فائدة في تأخره على طلب الوجه والمخرج البين، بل في ذلك البأس على الناس وإيهام للعوام، وقد تقدم القول في مسألة الأستواء. وقوله: {له ما في السماوات} الآية تماد في الصفة المذكورة المنبهة على الخالق المنعم، وفي قوله: {ما تحت الثرى} قصص في أمر الحوت ونحوه اختصرته لعدم صحته، والآية مضمنة أن كل موجود محدث فهو لله بالملك والاختراع ولا قديم سواه تعالى. و{الثرى} التراب الندي، وقوله: {وإن تجهر بالقول} معناه وإن كنتم أيها الناس إذ أردتم إعلام أحد بأمر أو مخاطبة أوثانكم وغيرها فأنتم تجهرون بالقول فإن الله الذي هذه صفاته {يعلم السر وأخفى} فالمخاطبة ب {تجهر} لمحمد عليه السلام وهي مراد جميع الناس إذ هي آية اعتبار، واختلف الناس في ترتيب {السر} وما هو {أخفى} منه، فقالت فرقة {السر} هو الكلام الخفي كقراءة السر في الصلاة، والأخفى هو ما في النفس، وقالت فرقة وهو ما في النفس متحصلاً، والأخفى هو ما سيكون فيها في المستأنف، وقالت فرقة {السر} هو ما في نفوس البشر، وكل ما يمكن أن يكون فيها في المستأنف بحسب الممكنات من معلومات البشر، والأخفى هو ما من معلومات الله لا يمكن أن يعلمه البشر البتة ع: فهذا كله معلوم لله عز وجل.وقد تؤول على بعض السلف أنه جعل {أخفى} فعلاَ ماضياً وهذا ضعيف، و{الأسماء الحسنى} يريد بها التسميات التي تضمنتها المعاني التي هي في غاية الحسن ووحد الصفة مع جمع الموصوف لما كانت التسميات لا تعقل، وهذا جار مجرى {مآرب أخرى} [طه: 18] {ويا جبال أوبي معه} [سبأ: 10] وغيره، وذكر أهل العلم أن هذه الأسماء هي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن لله تسعة وتسعين إسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة» وذكرها الترمذي وغيره مسنده.
والنار على البعد لا تحس إلا بالأبصار، فلذلك فسر بعضهم اللفظ برأيت، وآنس أعم من {رأى} لأنك تقول آنست من فلان خيراً أو شراً. والقبس الجذوة من النار تكون على رأس العود أو القصبة أو نحوه، والهدى أراد الطريق، أي لعلي أجد ذا هدى أي مرشداً لي أو دليلا، وان لم يكن مخبراً. والهدى يعم هذا كله وإنما رجا موسى عليه السلام هدى نازلته فصادف الهدى على الإطلاق، وفي ذكر قصة موسى بأسرها في هذه السورة تسلية للنبي عما لقي في تبليغه من المشقات وكفر الناس فإنما هي له على جهة التمثيل في أمره. وروي عن نافع وحمزة {لأهلهُ امكثوا} بضمة الهاء وكذلك في القصص، وكسر الباقون الهاء فيهما. وقوله تعالى {فلما أتاها} الضمير عائد على النار، وقوله: {نودي} كناية عن تكليم الله له، وفي {نودي} ضمير يقوم مقام الفاعل، وإن شئت جعلته موسى إذ قد جرى ذكره، وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي {إني} بكسر الألف على الإبتداء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو {أني} بفتح الألف على معنى لأجل أني {أنا ربك فاخلع نعليك}، و{نودي} قد توصل بحرف الجر وأنشد أبو علي: [الكامل] واختلف المتأولون في السبب الذي من أجله أمر بخلع النعلين، فقالت فرقة كانتا من جلد حمار ميت فأمر بطرح النجاسة، وقالت فرقة بل كانت نعلاه من جلد بقرة ذكي لكن أمر بخلعها لينال بركة الوادي المقدس وتمس قدماه تربة الوادي، وتحتمل الآية معنى آخر هو الأليق بها عندي، وذلك أن الله تعالى أمره أن يتواضع لعظم الحال التي حصل فيها، والعرف عند الملوك أن تخلع النعلان ويبلغ الإنسان إلى غاية تواضعه، فكأن موسى عليه السلام أمر بذلك على هذا الوجه، ولا نبالي كانت نعلاه من ميتة أو غيرها، و{المقدس} معناه المطهر، و{طوى} معناه مرتين مرتين، فقالت فرقة معناه قدس مرتين، وقالت فرقة معناه طويته أنت، أي سرت به، أي طويت لك الأرض مرتين من طيك، وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي {طوىً} بالتنوين على أنه اسم المكان، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو {طوى} على أنه اسم البقعة دون تنوين، وقرأ هؤلاء كلهم بضم الطاء، وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو بكسر الطاء، وقرأت فرقة {طاوي} وقالت فرقة هو اسم الوادي، و{طوى} على التأويل الأول بمنزلة قولهم ثنى وثنى أي مثنياً، وقرأ السبعة غير حمزة {وأنا اخترتك} ويؤيد هذه القراءة تناسبها مع قوله: {أنا ربك} وفي مصحف أبي بن كعب {وأني اخترتك}، وقرأ حمزة {وأنّا اخترناك} بالجمع وفتح الهمزة وشد النون، والآية على هذا بمنزلة قوله: {سبحان الذي أسرى بعبده} [الأسراء: 1] ثم قال: {وآتينا} [الإسراء: 2] فخرج من إفراد إلى جمع، وقرأت فرقة {وإنا اخترناك} يكسر الألف.قال القاضي أبو محمد: وحدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت أبا الفضل بن الجوهري يقول: لما قيل لموسى {فاستمع} وقف على حجر، واستند إلى حجر، ووضع يمينه على شماله وألقى ذقنه على صدره، ووقف يستمع وكان كل لباسه وصوفاً. وقرأت فرقة{بالواد المقدس طاوي}وقوله: {وأقم الصلاة لذكري} يحتمل أن يريد لتذكيري فيها أو يريد لأذكرك في عليين بها فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول واللام لام السبب، وقالت فرقة معنى قوله: {لذكري} أي عند ذكري إذا ذكرتني وأمري لك بها، فاللام على هذا بمنزلتها في قوله: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] وقرأت فرقة{للذكرى}، وقرأت فرقة{لذكرى}بغير تعريف، وقرأت فرقة{للذكر}.
|